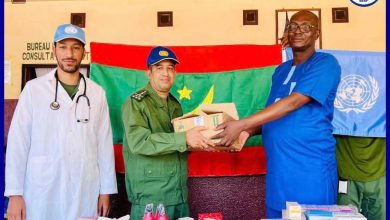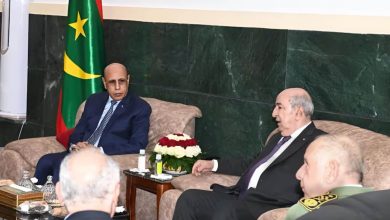الأخبار
انتخاب المهندس حمدي إبراهيم رئيسا لمجلس شورى تواصل
المتابع : انتخب أعضاء مجلس شورى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” المهندس حمدي ولد إبراهيم رئيسا للمجلس، وذلك لمأمورية ثانية، بعد أن قاد المجلس خلال المأمورية المنصرمة.
كما اختار المجلس أربعة نواب لرئيس المجلس، وهم خديجة سيديا، والدكتورة ياي انضو كوليبالي، وإسحاق ولد الكيحل، والشيخ الخليفة.
فيما اختار المجلس يحي ولد أبو بكر مقررا أول له، ومحموظ ولد سيدي محمد مقررا ثانيا.
ويعد المهندس ولد إبراهيم أحد قيادات الحزب البارزة، وانتخب نائبا عن الحزب في البرلمان خلال الإنابة 2013 – 2018، كما ترأس المؤتمر الثالث للحزب ديسمبر 2017.
وعقد مجلس شورى حزب “تواصل” مساء الثلاثاء أول اجتماع له، وذلك بعد انتخاب أعضائه في المؤتمر الرابع، والذي اختتم في الساعات الأولى من فجر الاثنين.